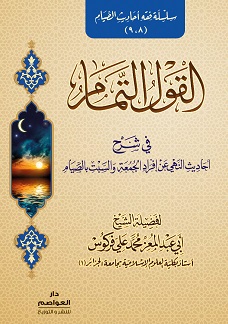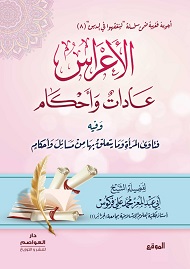العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
«التصفيف التاسع والثلاثون: الإيمان بالقَدَر (٣)»
الثامن والخمسون: [فصل: العمل بالشرع والجِدُّ في السعي مع الإيمان بالقَدَر]
الشَّرْعُ مَعْلُومٌ لَنَا، وَضَعَهُ اللهُ لِنُسَيِّرَ عَلَيْهِ أَعْمَالَنَا(١)، وَالقَدَرُ مُغَيَّبٌ عَنَّا، أَمَرَنَا اللهُ بِالإِيمَانِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى كَمَالِ العِلْمِ وَالإِرَادَةِ مِنْ صِفَاتِ رَبِّنَا؛ فَالقَدَرُ فِي دَائِرَةِ الاِعْتِقَادِ، وَالشَّرْعُ فِي دَائِرَةِ العَمَلِ.
وَعَلَيْنَا أَنْ نَعْمَلَ بِشَرْعِ اللهِ، وَنَتَوَسَّلَ إِلَى المُسَبَّبَاتِ المَشْرُوعَةِ بِأَسْبَابِهَا، وَنُؤْمِنَ بِسَبْقِ قَدَرِ اللهِ؛ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ مِنْهَا(٢)؛ فَمَنْ سَبَقَتْ لَهُ السَّعَادَةُ يُسِّرَ لِأَسْبَابِهَا، وَمَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشَّقَاوَةُ يُسِّرَ لِأَسْبَابِهَا(٣)؛ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(٤) رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ(٥)، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ(٦)، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ(٧) إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً»، فَقَالَ رَجُلٌ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ(٨)، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيَصِيرُ إِلَى الشَّقَاوَةِ؟» فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ»، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ اللهِ ـ تَعَالَى ـ: ﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ١٠﴾ [الليل]» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(٩).
وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ... كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١٠).
(١) في نسخة: «م.ف»: «وَضَعَه اللهُ لنَسِيرَ عليه في أعمالِنا».
(٢) في النسخة السابقةِ نَفْسِها: «إلَّا ما قدَّره اللهُ منها».
(٣) المُصنِّف رحمه الله ـ بعد تقريره لمذهبِ أهلِ السُّنَّةِ في: وجوبِ الإيمان بجميعِ المَقادير: خيرِها وشرِّها، قليلِها وكثيرِها، وأنها واقعةٌ مِن الله تعالى على العباد، جاريةٌ على مقتضى قضائه وقَدَره، وسائرةٌ تحت تصرُّفه وإرادته، لا مُبَدِّلَ لكلماته ولا رادَّ لحُكْمِه كما تَقدَّمَ ـ اعتمد في تقريره العَقَديِّ على النصوص الشرعية الدالَّةِ على عِلْمِ الله السابقِ بالأشياءِ قبل كونها، وما كَتَبَه اللهُ في اللوح المحفوظ مِن مَقاديرِ الخَلْقِ، وما تَضمَّنَتْه النصوصُ مِن مرتبتَيِ المَشيئةِ والخَلْق؛ فما شاءَ كان وما لم يَشَأْ لم يكن، وما أصاب العبدَ لم يكن ليُخْطِئَه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبَه.
ثمَّ انتقل ـ رحمه الله ـ بعد ذلك إلى بيانِ عَدَمِ مُنافاةِ حقيقةِ التوكُّل بمُباشَرةِ الأسباب المأمورِ بها شرعًا وعقلًا وفطرةً؛ وذلك أنه إذا كان الاعتقادُ قائمًا على أنَّ جميع الأشياءِ تَسيرُ وَفْقَ ما سَبَقَ في القضاءِ وجَرَتْ به المَقاديرُ؛ فإنه لا يَقْتضي مِن العبدِ تَرْكَ القيام بمُوجَبِ العبودية مِن التقرُّب إلى الله بالأعمال الصالحة وسائرِ الطاعات والقُرُبات بامتثالِ أوامرِ الشرع واجتنابِ نواهيه، كما لا يَلْزَمُ منه الاستسلامُ للخمول والدَّعَةِ والبطالةِ المُفْضِيةِ إلى تعطيلِ حقوقِ الله اتِّكاءً واتِّكالًا على قضاءِ الله وقَدَرِه؛ بل الأمرُ على خلافِ ذلك؛ فالعبدُ المؤمنُ مُطالَبٌ بالقيام بحقوقِ الله على الوجه المَرْضِيِّ مع الإيمان بما أخبر اللهُ ـ تعالى ـ ورسولُه مِنْ أمور الغيب وما يجري به قضاءُ الله وقَدَرُه، وقد وَصَفَ اللهُ ـ تعالى ـ عِبادَه المؤمنين المُتَّقين بذلك بقوله: ﴿الٓمٓ ١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٤ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥﴾ [البقرة].
قال الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ في [«أعلام الحديث» (١/ ٧٢٠)]: «قلت: مَعْنَى قولهم: «أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ» [سيأتي تخريجه، انظر: الرابط]: مُطالَبةٌ منهم بمُوجَبِ أمرٍ تحته تعطيلُ العبودية؛ وذلك أنَّ إخبارَه صلَّى الله عليه وسلَّم إيَّاهم عن سَبْقِ الكتابِ بسعادةِ السعيد وشقاوةِ الشقيِّ إخبارٌ عن غَيْبِ عِلْمِ الله فيهم، وهو حُجَّةٌ عليهم؛ فرَامَ القومُ أَنْ يَتَّخِذوه حُجَّةً لأَنْفُسهم في تركِ العمل ويتَّكِلوا على الكتاب السابق؛ فأَعْلَمَهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ هاهنا أمرَيْن لا يُبْطِلُ أَحَدُهما الآخَرَ:
باطنٌ: وهو العِلَّةُ المُوجِبةُ في حكمِ الربوبية.
وظاهرٌ: وهو السِّمَةُ اللازمةُ في حَقِّ العبودية، وإنما هو أمارةٌ مُخيَّلةٌ في مُطالَعةِ عِلْمِ العواقبِ غيرُ مُفيدةٍ حقيقةَ العلمِ به، ويُشْبِهُ أَنْ يكونوا ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ إنما عُومِلوا بهذه المُعامَلةِ وتُعُبِّدُوا بهذا النوعِ مِن التعبُّدِ لِيَتعلَّقَ خوفُهم بالباطن المُغيَّبِ عنهم ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم ـ والخوفُ والرجاءُ مَدْرَجَتا العبودية ـ فيَسْتكمِلوا بذلك صفةَ الإيمان، وبيَّن لهم أنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له، وأنَّ عَمَله في العاجلِ دليلُ مَصيرِه في الآجل؛ ولذلك مثَّل بقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ١٠﴾ [الليل].
وهذه الأمورُ إنما هي في حُكْمِ الظاهرِ مِن أحوالِ العِباد، ومِنْ وراءِ ذلك عِلْمُ الله فيهم وهو الحكيمُ الخبير، ﴿لَا يُسَۡٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسَۡٔلُونَ ٢٣﴾ [الأنبياء].
فإذا طَلَبْتَ لهذا الشأنِ نظيرًا مِن العلمِ يجمعُ لك هذين المَعْنيَيْنِ فاطْلُبْهُ في بابِ أَمْرِ الرزقِ المقسوم مع الأمر بالكسب، وأَمْرِ الأجل المضروب في العمر مع التعالج بالطبِّ؛ فإنك تَجِدُ المُغيَّبَ منهما عِلَّةً مُوجِبةً، والظاهرَ الباديَ سببًا مُخيَّلًا، وقد اصطلح الناسُ خَوَاصُّهم وعَوَامُّهم على أنَّ الظاهر منهما لا يُتْرَكُ للباطن».
وقال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في [«الجواب الكافي» (٣٩)]: «وقد رتَّبَ اللهُ ـ سبحانه ـ حصولَ الخيراتِ في الدنيا والآخرة، وحصولَ السرورِ في الدنيا والآخرةِ في كتابه على الأعمال، تَرَتُّبَ الجزاءِ على الشرط، والمعلولِ على العلَّة، والمسبَّبِ على السبب، وهذا في القرآنِ يَزيدُ على ألفِ موضعٍ... وبالجملة فالقرآنُ مِن أوَّلِه إلى آخِرِه صريحٌ في تَرتُّبِ الجزاءِ بالخير والشرِّ والأحكامِ الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكامِ الدنيا والآخرة ومَصالِحِهما ومَفاسِدِهما على الأسباب والأعمال».
قلت: وإذا كان تَعَلُّقُ الأسبابِ بمُسَبَّباتها وارتباطُها بها وبناؤها عليها ممَّا قَضَاهُ اللهُ بحكمته معلومًا تَشْهَدُ بذلك العامَّةُ والخاصَّة؛ فإنَّ الأسباب نَفْسَها هي ـ أيضًا ـ واقعةٌ تحت إرادةِ الله وتَصَرُّفِهِ، وجاريةٌ على وَفْقِ قضاءِ اللهِ وقَدَرِه؛ وعليه فالأسبابُ ـ وإِنْ أَخَذَ بها العبدُ ـ والأعمالُ ـ وإِنْ باشَرَها ـ فلا يجوز له أَنْ يَتوكَّلَ عليها أو يَعْتمِدَ عليها، وإنما الواجبُ على العبدِ أَنْ يَتوكَّلَ على خالِقِها ومُنْشِئِها.
وقد نَقَلَ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ في [«مجموع الفتاوى» (٨/ ٧٠)] عن بعضهم أنه قال: «الالتفاتُ إلى الأسبابِ شركٌ في التوحيد، ومحوُ الأسباب أَنْ تكون أسبابًا نقصٌ في العقل، والإعراضُ عن الأسباب بالكُلِّيَّةِ قَدْحٌ في الشرع، ومُجرَّدُ الأسبابِ لا يُوجِبُ حصولَ المسبَّب؛ فإنَّ المطر إذا نَزَلَ وبُذِرَ الحبُّ لم يكن ذلك كافيًا في حصولِ النبات، بل لا بُدَّ مِن ريحٍ مُرَبِّيَةٍ بإذنِ الله، ولا بُدَّ مِن صَرْفِ الانتفاء عنه؛ فلا بُدَّ مِن تمامِ الشروط وزوالِ الموانع، وكُلُّ ذلك بقضاءِ الله وقَدَرِه، وكذلك الولدُ لا يُولَدُ بمُجرَّدِ إنزالِ الماء في الفَرْج، بل كم مَنْ أَنْزَلَ ولم يُولَدْ له، بل لا بُدَّ مِنْ أنَّ اللهَ شاءَ خَلْقَه، فتَحْبَلُ المرأةُ وتُرَبِّيهِ في الرَّحِم، وسائرِ ما يَتِمُّ به خَلْقُه مِنَ الشروط وزوالِ الموانع».
(٤) هو الصحابيُّ الجليل أبو الحسنِ عليُّ بنُ أبي طالب بنِ عبد المُطَّلِبِ بنِ هاشمٍ القُرَشيُّ الهاشميُّ المكِّيُّ ثمَّ المَدَنيُّ الكوفيُّ، أميرُ المؤمنين وابنُ عمِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وصِهْرُه على ابنته فاطمةَ رضي الله عنها، وأبو السِّبْطين، وأَحَدُ السابقين الأوَّلين، له مَناقِبُ عديدةٌ وفضائلُ كثيرةٌ. مات شهيدًا سنة (٤٠ﻫ).
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣٣٧، ٣/ ١٩)، «المَعارف» لابن قُتَيْبة (٢٠٣)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ١٩١)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (٣/ ١٠٨٩)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٣٣)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٣٧)، «أُسْد الغابة» (٤/ ١٦) و«الكامل» (٣/ ٣٨٧) كلاهما لابن الأثير، «معرفة القُرَّاءِ الكِبار» (١/ ٢٥) و«الكاشف» (٢/ ٢٨٧) و«دُوَل الإسلام» (١/ ٢٨) كُلُّها للذهبي، «البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ٣٢٤)، «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٥٠٧)، «طبقات الحُفَّاظ» للسيوطي (١٤)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٤٩).
(٥) الغَرْقَد: شُجَيْرةٌ تَسْمو مِن مترٍ إلى ثلاثةٍ مِن الفصيلة الباذنجانية: ساقُها وفروعُها بِيضٌ تُشْبِهُ العَوْسَجَ في أوراقها اللحمية وفروعِها الشائكة، وأزهارُها الطويلةُ عَبِقَةُ الريحِ بيضاءُ مُخْضَرَّةٌ، وثمرتُها مخروطيةُ الشكل، ومنه قِيلَ لمقبرة أهل المدينة: بقيعُ الغرقد؛ لأنه كان فيه غرقدٌ ثمَّ قُطِعَ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٦٢)، «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٥٠)].
(٦) المِخْصَرة: ما يَخْتصرُهُ الإنسانُ بيده فيُمْسِكُه مِن عصًا أو عُكَّازةٍ أو مِقْرَعةٍ أو قضيبٍ، وقد يتَّكِئُ عليه [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٣٦)].
(٧) النَّفْسُ المنفوسة هي: المولودة، والمنفوسُ: الطفلُ الحديثُ الولادةِ، يُقالُ: «نُفِسَتِ المرأةُ ونَفِسَتْ فهي منفوسةٌ ونُفَسَاءُ» إذا وَلَدَتْ، فأمَّا الحيضُ فلا يُقالُ فيه إلَّا: «نَفِسَتْ» بالفتح، ويقال: إنما سُمِّيَتِ المرأةُ: نُفَساءَ لسيلانِ الدم، والنَّفْسُ: الدَّمُ [انظر: «مَعالِم السنن» للخطَّابي (٥/ ٦٨)، «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٩٥)].
(٨) وفي روايةِ أبي داود ومسلمٍ: «فَقَالَ رَجُلٌ [مِنَ القَوْمِ]: «يَا نَبِيَّ اللهِ، أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟»» ـ وسيأتي تخريجه، انظر: الرابط ـ.
والرَّجُلُ القائلُ هو عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه، وقِيلَ: سُرَاقةُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه، وقِيلَ: رجلٌ مِن الأنصار، وقِيلَ: غيرُ هؤلاء. والجمعُ بين هذه الأقوالِ: كثرةُ السائلين عن ذلك وتَعدُّدُهم [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٤٩٧)].
(٩) أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» (٣/ ٢٢٥) بابُ موعظةِ المُحدِّثِ عند القبر، وفي «التفسير» (٨/ ٧٠٨) باب: ﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥﴾ [الليل]، وفي «الأدب» (١٠/ ٥٩٧) بابُ الرجلِ يَنْكُت الشيءَ بيده في الأرض، وفي «القَدَر» (١١/ ٤٩٤) باب: ﴿وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا ٣٨﴾ [الأحزاب]، وفي «التوحيد» (١٣/ ٥٢١) بابُ قولِ الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠]. ومسلمٌ في «القَدَر» (١٦/ ١٩٥) بابُ كيفيةِ خَلْقِ الآدميِّ في بطن أمِّه، وأبو داود في «السنَّة» (٥/ ٦٨) بابٌ في القَدَر، والترمذيُّ في «التفسير» (٥/ ٤٤١) باب: ومِن سورة: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ١﴾ [الليل]، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» (١/ ٣٠) باب (١٠)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٣٧) [طبعة شاكر]، مِن حديثِ عليٍّ رضي الله عنه.
قال الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ في [«مَعالِم السنن» (٥/ ٦٨)]: «فهذا الحديثُ إذا تَأمَّلْتَه أَصَبْتَ منه الشفاءَ فيما يَتَخالَجُكَ مِن أَمْرِ القَدَر؛ وذلك أنَّ السائلَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم والقائلَ له: «أفلا نَمْكُثُ على كتابنا ونَدَعُ العملَ؟» لم يترك شيئًا ممَّا يدخل في أبوابِ المُطالَباتِ والأسئلةِ الواقعةِ في بابِ التجويرِ والتعديلِ إلَّا وقد طَالَبَ به وسَأَلَ عنه؛ فأَعْلَمَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ القياسَ في هذا البابِ متروكٌ، والمُطالَبةَ عليه ساقطةٌ، وأنه أمرٌ لا يُشْبِهُ الأمورَ المعلومة التي قد عُقِلَتْ مَعانِيهَا وجَرَتْ مُعامَلاتُ البشرِ فيما بينهم عليها، وأخبر أنه إنما أَمَرَهم بالعمل ليكون أمارةً في الحالِ العاجلةِ لِمَا يصيرون إليه في الحالِ الآجلة: فمَنْ تَيسَّرَ له العملُ الصالح كان مأمولًا له الفوزُ، ومَنْ تَيسَّرَ له العملُ الخبيثُ كان مَخوفًا عليه الهلاكُ، وهذه أماراتٌ مِن جهةِ العلم الظاهر وليسَتْ بمُوجِباتٍ؛ فإنَّ الله ـ سبحانه ـ طَوَى عِلْمَ الغَيْبِ عن خَلْقِه وحَجَبَهم عن دركِه، كما أَخْفى أَمْرَ الساعةِ فلا يعلم أَحَدٌ مَتَى إبَّانُ قيامِها، ثمَّ أَخْبَرَ على لسانِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعضَ أماراتها وأشراطِها فقال: مِنْ أشراطِ الساعة: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ ربَّتَها، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُراةَ العَالةَ رِعاءَ الشاءِ يَتطاوَلون في البنيان، ومنها كَيْتَ وكَيْتَ».
وقال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في [«شفاء العليل» (١/ ١١٩)] شارحًا حديثَ عليٍّ رضي الله عنه وغيرَه مِنَ الأحاديثِ الأخرى في مَعْناهُ: «فاتَّفقَتْ هذه الأحاديثُ ونظائرُها على أنَّ القَدَرَ السابقَ لا يمنع العملَ ولا يُوجِبُ الاتِّكالَ عليه، بل يُوجِبُ الجِدَّ والاجتهاد؛ ولهذا لمَّا سَمِعَ بعضُ الصحابةِ ذلك قال: «ما كُنْتُ أَشَدَّ اجتهادًا منِّي الآنَ» [رواهُ ابنُ حِبَّان في «صحيحه» (٢/ ٤٩) عن سُراقةَ بنِ مالكٍ رضي الله عنه].
وهذا ممَّا يدلُّ على جلالةِ فقهِ الصحابةِ ودِقَّةِ أفهامهم وصِحَّةِ علومهم؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَخْبَرَهم بالقَدَرِ السابق وجَرَيانِه على الخليقة بالأسباب، وأنَّ العبد يَنالُ ما قُدِّرَ له بالسبب الذي أُقْدِرَ عليه ومُكِّنَ منه وهُيِّئَ له؛ فإذا أَتَى بالسبب أَوْصَلَهُ إلى القَدَرِ الذي سَبَقَ له في أمِّ الكتاب، وكُلَّما ازداد اجتهادًا في تحصيلِ السبب كان حصولُ المقدورِ أَدْنَى إليه، وهذا كما إذا قُدِّرَ له أَنْ يكون مِنْ أَعْلَمِ أهلِ زمانه؛ فإنه لا يَنالُ ذلك إلَّا بالاجتهاد والحرص على التعلُّمِ وأسبابِه، وإذا قُدِّرَ له أَنْ يُرْزَقَ الولدَ لم يَنَلْ ذلك إلَّا بالنكاح أو التسرِّي والوطء، وإذا قُدِّرَ له أَنْ يَسْتَغِلَّ مِنْ أرضِه مِن المُغَلِّ كذا وكذا لم يَنَلْه إلَّا بالبذر وفعلِ أسبابِ الزرع، وإذا قُدِّرَ الشِّبَعُ والرِّيُّ والدِّفْءُ فذلك موقوفٌ على الأسباب المُحَصِّلةِ لذلك مِنَ الأكل والشرب واللُّبس؛ وهذا شأنُ أمورِ المَعاش والمَعاد؛ فمَن عطَّل العملَ اتِّكالًا على القَدَرِ السابقِ فهو بمنزلةِ مَن عطَّل الأكلَ والشربَ والحركةَ في المَعاشِ وسائرِ أسبابِه اتِّكالًا على ما قُدِّرَ له، وقد فَطَرَ اللهُ ـ سبحانه ـ عِبادَه على الحرصِ على الأسباب التي بها قِوامُ مَعايِشِهم ومَصالِحِهم الدنيوية، بل فَطَرَ اللهُ على ذلك سائِرَ الحيوانات؛ فهكذا الأسبابُ التي بها مَصالِحُهم الأخرويةُ في مَعادِهم؛ فإنه ـ سبحانه ـ ربُّ الدنيا والآخرة، وهو الحكيمُ بما نَصَبَه مِنَ الأسباب في المَعاش والمَعاد، وقد يَسَّرَ كُلًّا مِنْ خَلْقه لِمَا خَلَقَه له في الدنيا والآخرة؛ فهو مُهَيَّأٌ له مُيَسَّرٌ له؛ فإذا عَلِمَ العبدُ أنَّ مَصالِحَ آخِرَته مُرْتَبِطةٌ بالأسباب المُوصِلةِ إليها كان أَشَدَّ اجتهادًا في فِعْلِها والقيامِ بها مِنْهُ في أسبابِ مَعاشِه ومَصالِحِ دُنْياهُ».
(١٠) أخرجه مسلمٌ في «القَدَر» (١٦/ ٢١٥) بابُ الإيمانِ بالقَدَر والإذعانِ له، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» (١/ ٣١) باب (١٠) وفي «الزهد» (٢/ ١٣٩٥) باب (١٤)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٣٦٦، ٣٧٠)، وابنُ أبي عاصمٍ في «السنَّة» (١٥٧)، مِن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعضِ ألفاظِه: «قَدَّرَ اللهُ» بَدَلَ: «قَدَرُ اللهِ».
فالمُصنِّفُ ـ رحمه الله ـ أرادَ أَنْ يُبيِّنَ ـ مِنْ خلالِ استدلالِه بهذا الحديثِ وما تَقَدَّمَه ـ أنَّ القَدَرَ السابقَ لا يَمْنَعُ العملَ ولا يُوجِبُ الاتِّكالَ؛ فلا يجوز للعبد الحريصِ على إيمانه أَنْ يترك العملَ بدَعْوَى أنَّ قَدَرَ الله ماضٍ فيه؛ فإنَّ ذلك عَجْزٌ وكَسَلٌ مُعَطِّلٌ عن طَلَبِ الطاعةِ مِن الله والاستعانةِ به، بل الواجبُ على المؤمنِ المُتمتِّعِ بعزيمةِ نفسٍ قويَّةٍ وقريحةٍ شديدةٍ في تحصيلِ ما ينفعه في الدنيا والآخرةِ أَنْ يكون أَكْثَرَ جِدِّيَّةً في تحقيقِ مُوجَباتِ العبوديةِ وأَشَدَّ اجتهادًا في دركِ المَطالِبِ الشرعية، طلبًا لها وعملًا بمُقْتضاها ومُحافَظةً عليها، بعزيمةٍ أكيدةٍ ورغبةٍ مُلِحَّةٍ؛ فيَبْذلُ ما في وُسْعِه للقيام بأمرِ الله والأخذِ بالأسباب المُوجِبةِ لنَفْعِه وصلاحِه، فإِنْ لم يُوَفَّقْ لمُرادِه أو حَلَّتْ عليه مُصيبةٌ فلا ينظر إلى القَدَرِ ويقضي وقتَه في التأسُّف والتحسُّر الذي يُوحِي بمُنازَعةِ القَدَر، ولا يقول: «لو أنِّي فَعَلْتُ لَكان كذا» فيُقدِّرُ ما لم يَقَعْ ويتمنَّى أَنْ لو كان وَقَعَ؛ فإنَّ «لو» إذا استُعْمِلَتْ في جانِبِها المذمومِ تُورِثُ حسرةً وحزنًا، ولا يُجْدِيهِ ذلك نفعًا، وإنما الذي ينفعه هو التسليمُ للقَدَر، يقول: «قَدَرُ اللهِ وما شاءَ فَعَلَ» [انظر: «الاحتجاج بالقَدَر» لابن تيمية (٢٧)، «شرح مسلم» للنووي (١٦/ ٢١٥)].
ومِن خلالِ مَعاني هذه الأحاديثِ يظهر ـ جَلِيًّا ـ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْشَدَ أمَّتَه إلى نظامَيْن هما مَحَلُّ السعادةِ وهُما: نظامُ التوحيد، ونظامُ الشرع، كما أَفْصَحَ عن ذلك ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في [«شفاء العليل» (١/ ١٢١)] بقوله: «فالقَدَرُ السابقُ مُعِينٌ على الأعمالِ وباعثٌ عليها ومُقْتَضٍ لها، لا أنه مُنَافٍ لها وصادٌّ عنها، وهذا موضعُ مَزَلَّةِ قَدَمٍ، مَنْ ثَبَتَتْ قَدَمُه عليه فازَ بالنعيم المُقيم، ومَنْ زلَّتْ قَدَمُه عنه هَوَى إلى قرارِ الجحيم؛ فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْشَدَ الأمَّةَ في القَدَرِ إلى أَمْرَين هُمَا سَبَبَا السعادة:
• الإيمان بالأقدار؛ فإنه نظامُ التوحيد.
• والإتيان بالأسباب التي تُوصِلُ إلى خيره وتَحْجُزُ عن شرِّه، وذلك نظامُ الشرع. فأَرْشَدَهُم إلى نظامِ التوحيد والأمر، فأَبَى المُنْحَرِفون إلَّا القَدْحَ بإنكاره في أصلِ التوحيد أو القَدْحَ بإثباته في أصل الشرع، ولم تَتَّسِعْ عقولُهُمْ ـ التي لم يُلْقِ اللهُ عليها مِن نوره ـ للجمع بين ما جَمَعَتِ الرُّسُلُ جميعُهم بينه وهو: القَدَرُ والشرع، والخَلْقُ والأمر، ﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣﴾ [البقرة]، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم شديدُ الحرصِ على جَمْعِ هذين الأمرين للأمَّة، وقد تَقَدَّمَ قولُه: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ»، وأنَّ العاجز مَن لم يَتَّسِعْ للأمرين وباللهِ التوفيقُ».
هذا، وجديرٌ بالإفادة أنَّ «لو» حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ بخلافِ «لولا» فهي حرفُ امتناعٍ لوجودٍ، وتأتي «لو» لِتُفيدَ ـ أيضًا ـ مَعانيَ وأغراضًا أخرى كالتمنِّي والتعليل والعَرْض والطلب والحضِّ.
و«لو» ـ في الحديث ـ: تَحَسُّرٌ وحزنٌ تفتح عَمَلَ الشيطانِ بأَنْ يُلْقِيَ في القلب مُعارَضةَ القَدَرِ ويُوَسْوِسَ به، وقد استثنى العُلَماءُ مِن ذلك جوازَ «لو» في بابِ تَمَنِّي الخيرِ وفِعْلِه كالتأسُّفِ على ما فاتَ مِن طاعةِ الله ـ تعالى ـ، أو ما هو مُتَعَذِّرٌ عليه في ذلك، وعليه يُحْمَلُ أَكْثَرُ استعمالاتها الواردةِ في الأحاديث [انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٦/ ٢١٦)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٢٢٨)]، وقد عَقَدَ البخاريُّ في «الصحيح» مِن كتابِ «التمنِّي» (١٣/ ٢٢٤) بابًا تَرْجَمَ له ﺑ: «بابُ ما يجوز مِن اللَّو، وقولِه ـ تعالى ـ: ﴿لَوۡ أَنَّ لِي بِكُمۡ قُوَّةً﴾ [هود: ٨٠]».
وقد ضَبَطَ الشيخُ السعديُّ ـ رحمه الله ـ في [«القول السديد» (١٧٠)] هذه المسألةَ بتقسيمٍ ثُنائيٍّ جَلِيٍّ نَنْقُلُ نصَّه فيما يلي: «اعْلَمْ أنَّ استعمالَ العبدِ لِلَفظةِ: «لو» تَقَعُ على قسمين: مذمومٍ ومحمودٍ:
• أمَّا المذمومُ فأَنْ يَقَعَ منه أو عليه أمرٌ لا يُحِبُّه فيقول: «لو أنِّي فَعَلْتُ كذا لَكان كذا»؛ فهذا مِن عَمَلِ الشيطان؛ لأنَّ فيه محذورَيْن:
أَحَدُهما: أنها تفتح عليه بابَ الندمِ والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقُه وليس فيه نفعٌ.
الثاني: أنَّ في ذلك سوءَ أَدَبٍ على الله وعلى قَدَرِه؛ فإنَّ الأمور كُلَّها والحوادثَ دقيقَها وجليلَها بقضاءِ الله وقَدَرِه، وما وَقَعَ مِن الأمورِ فلا بُدَّ مِن وقوعِه ولا يمكن رَدُّه؛ فكان في قوله: «لو كان كذا» أو «لو فَعَلْتُ كذا كان كذا» نوعُ اعتراضٍ ونوعُ ضَعْفِ إيمانٍ بقضاءِ الله وقَدَرِه.
ولا رَيْبَ أنَّ هذين الأمرين المحذورين لا يتمُّ للعبد إيمانٌ ولا توحيدٌ إلَّا بتركهما.
• وأمَّا المحمود مِنْ ذلك فأَنْ يقولها العبدُ تمنِّيًا للخير:
ـ كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَأَهْلَلْتُ بِالعُمْرَةِ» [أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» (٣/ ٥٠٤) باب: تقضي الحائضُ المَنَاسِكَ كُلَّها إلَّا الطواف، ومسلمٌ في «الحجِّ» (٨/ ١٦٣) بابُ بيانِ وجوهِ الإحرام، مِن حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما].
ـ وقولِه في الرجل المُتَمَنِّي للخير: «لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَالِ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلَانٍ» [أخرجه الترمذيُّ في «الزهد» (٤/ ٥٦٢) بابُ ما جاء: «مَثَلُ الدنيا مَثَلُ أربعةِ نَفَرٍ»، وابنُ ماجه في «الزهد» (٢/ ١٤١٣) باب النيَّة، مِن حديثِ أبي كَبْشَةَ الأنماريِّ رضي الله عنه. قال الترمذيُّ: «حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي» (٢٣٢٥) و«صحيح ابنِ ماجه» (٤٣٢٥)].
ـ و«لَوْ صَبَرَ أَخِي مُوسَى لَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ نَبَإِهِمَا» أي: في قصَّته مع الخَضِر [أخرجه البخاريُّ في «الأنبياء» (٦/ ٤٣٣) بابُ حديثِ الخَضِر مع موسى عليهما السلام، ومسلمٌ في «الفضائل» (١٥/ ١٤١) بابُ فضائلِ الخَضِر عليه السلام، وهو جزءٌ مِن حديثٍ طويلٍ عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ رضي الله عنه].
وكما أنَّ «لو» إذا قالها مُتَمَنِّيًا للخير فهو محمودٌ؛ فإذا قالها مُتَمَنِّيًا للشرِّ فهو مذمومٌ؛ فاستعمالُ «لو» تكون بحَسَبِ الحالِ الحاملِ عليها:
• فإِنْ حَمَلَ عليها الضَّجَرُ والحزنُ وضَعْفُ الإيمانِ بالقضاءِ والقَدَرِ أو تَمَنِّي الشرِّ كان مذمومًا.
• وإِنْ حَمَلَ عليها الرغبةُ في الخير والإرشادِ والتعليم كان محمودًا».
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 6264 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)