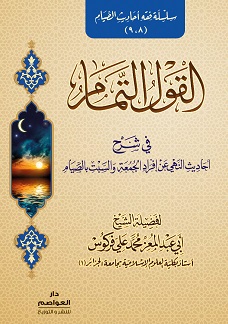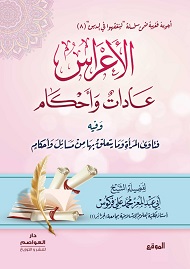العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
«التصفيف التاسع: بيـانُ معنى الإيمـان (٣)»
السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ: يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الأَعْمَالِ وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا(١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾(٢)، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾(٣)، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(٤)، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ(٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ...
(١) عقيدةُ أهل السُّنَّة والجماعةِ أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص، وهو الذي دلَّت عليه نصوصُ الكتاب والسنَّة وإجماعُ السلف الصالح، والإيمانُ يزيد بالطاعة حتى يكون كالجبال، وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه شيءٌ، ومَن ترك شيئًا من الطاعات نقص إيمانُه بقدر ما ترك، فإن اعتقد بقلبه ونطق بالشهادتين فهو مسلمٌ، فإن مات قبل تمكُّنه من العمل مات مؤمنًا وتحقَّق إيمانُه بالاعتقاد والقولِ لعدم تمكُّنه من العمل، أمَّا إن ترك العملَ بالكلِّيَّة مع تمكُّنه منه وقدرته عليه وعدمِ وجود المانع لأدائه، وحصلت له المهلة لذلك؛ انعدم ما في قلبه من الإيمان وانقلب كافرًا تأسيسًا على أنَّ الإيمان -عند أهل السنَّة- لا يتحقَّق إلاَّ بالاعتقاد والقول والعمل، إذ لا يصحُّ إيمانُه إلاَّ بعمل ظاهرٍ يدلُّ على صحَّة دعواه.
وعقائدُ طوائفِ المرجئة -وإن وافقت أهلَ السنَّة- في أنَّ الإيمان الكاملَ الذي ينفع في الدارين لا بدَّ فيه من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؛ إلاَّ أنَّ من وجوه الفَرْقِ بينهما أنَّ المرجئة جعلت العملَ ركنًا من الإيمان الكامل لا ركنًا من أصل الإيمان الذي لا نجاة من الخلود في النار إلاَّ به، فوافقت المرجئةُ أهلَ السُّنَّةِ في القول بالزيادة والنقصان من جهة الأعمال الظاهرة وهذا محلُّ اتِّفاقٍ، وخالفت في تفاضُل الأعمال بالإيمان بالنظر إلى أنَّ طوائف المرجئة مُجمعةٌ على عدم دخول العمل في مسمَّى الإيمان -كما تقدَّم في تعريفهم للإيمان-، وحكى الفضيل بنُ عياضٍ عنهم أنهم قالوا: «إنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان» [«السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (١/ ٣٧٥)]، وقال ابن تيمية في [«مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٦٢)] في بيان هذه الحقيقة بقوله: «والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوهٍ متعدِّدةٍ: أحدها: الأعمال الظاهرة، فإنَّ الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا ممَّا اتَّفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكنَّ نزاعهم في دخول ذلك في مسمَّى الإيمان»، وقال في موضعٍ آخر من [«مجموع الفتاوى» (٦/ ٤٧٩)]: «وأمَّا زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتَّفقٌ عليه».
قلت: وليس المقصود بأعمال الجوارح تَرْكَ المحرَّمات فقط، وإنما فعلُ المباني وأداء الواجبات، أمَّا أعمال القلوب فإنَّ عامَّة فِرَقِ المرجئة تُدخلها في الإيمان كما نقله أهلُ المقالات عنهم. [انظر: «مقالات الإسلاميِّين» للأشعري (١٩٧)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٥٤٣)].
ويظهر من خلال أهل المقالات أنَّ طوائف المرجئة تعتقد أنَّ الأعمال ليست من الإيمان؛ لأنَّ الله فَرَّق بين الإيمان والأعمال في كتابه، فإيمانُ الخلق متماثلٌ لا متفاضلٌ، وإنما يجري التفاضل في غير الإيمان من الأعمال بالزيادة والنقصان، وهو وجه المخالفة مع أهل السُّنَّة، ومع ذلك فالزيادة والنقصان عند المرجئة ليستا على حدٍّ سواءٍ، فتجوز الزيادة -من جهة الأعمال- مطلقةً من غير تقييدٍ، ويجب تقييد النقصان بحدٍّ أدنى، لذلك كانت المرجئة «تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة» [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٤٠٤)، «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيِّم» لأحمد بن إبراهيم (٢/ ١٤٦)]، وهذا وجهٌ آخَرُ يخالفون به أهلَ السنَّة من جهة أنَّ الإيمان -عندهم- لا يتوقَّف نقصانُه إلى حدٍّ معيَّنٍ، بل نصُّوا على أنَّ الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيءٌ.
وبناءً على ما تقدَّم فإنَّ المرجئة لم تنازِع في الحكم، وإنما نازعت في الاسم، فيجوز على الشخص أن يكون مثابًا معاقبًا، محمودًا مذمومًا، لكن لا يجوز أن يكون معه بعضُ الإيمان دون بعضٍ، قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٣٥٤): «وأمَّا أهلُ السنَّة والجماعةِ والصحابةُ والتابعون وسائرُ طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام مِن مرجئة الفقهاء والكرَّامية والكُلاَّبية والأشعرية والشيعة مرجئِهم وغيرِ مرجئهم فيقولون: إنَّ الشخص الواحد قد يعذِّبه الله بالنار ثمَّ يدخله الجنَّة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيِّئاتٌ عذِّب بها وله حسناتٌ دخل بها الجنَّة، وله معصيةٌ وطاعةٌ باتِّفاقٍ؛ فإن هؤلاء الطوائفَ لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه».
وأصل ضلالهم اعتقادُهم أنَّ الإيمان شيءٌ واحدٌ لا يتبعَّض ولا يتجزَّأ، فمتى ذهب بعضُه ذهب سائرُه، وهو الأصل الذي التزمه -أيضًا- الخوارج والمعتزلة، غير أنَّ الفَرْقَ بينهما في النتيجة يظهر في أنَّ المرجئة أخذوا بشِقِّ نصوص الوعد في عدم خلود أصحاب الكبائر مع إهمالهم للشِّقِّ الآخَر المتمثِّل في نصوص الوعيد الدالَّة على زوال الاسم المطلق عنهم والخلودِ في النار الذي أخذ به الخوارجُ والمعتزلة على تفصيلٍ سابقٍ.
وهذا الأصل باطلٌ كان له الأثر البليغ في مخالفتهم لأهل السنَّة في الاسم دون الحكم، حيث قرَّروا أنَّ إيمان الفاسق كاملٌ لا تؤثِّر فيه الذنوب، وإيمانُه كإيمان جبريل وميكائيل مع موافقتهم أهلَ السنَّة في حكمه بأنه مستحِقٌّ للعقاب، فلا تلازُم -عند المرجئة- بين الاسم والحكم في حقِّ الفاسق؛ لأنَّ المرجئة لا تُنازِع في أنَّ الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة، والطاعةُ من ثمراته ونتائجه، ولكن تُنازِع: هل يستلزم الطاعةَ؟ واعتقادِهم انتفاءَ التلازم بين الأعمال والإيمان، إذ إنَّ الإيمان الذي في القلب يكون تامًّا بدون شيءٍ من الأعمال، فالأعمال -عندهم- ثمرةٌ للإيمان بمنزلة السبب مع المسبَّب أي: أنَّ الإيمان الباطن قد يكون سببًا وقد يكون الباطن تامًّا كاملاً وهي لم توجَد، قال ابن تيمية -رحمه الله- في [«مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٠٤)]: «والتحقيق أنَّ إيمان القلب التامَّ يستلزم العملَ الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمانٌ تامٌّ بدون عملٍ ظاهرٍ».
قلت: ومِن هنا ظهرت وسطيةُ أهل السُّنَّة في مرتكب الكبيرة بين من يجعله كاملَ الإيمان وبين من يجعله ذاهبَ الإيمان، وإنما الفاسق الملِّيُّ ناقصُ الإيمان، فهو مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بمعصيته.
هذا، والمصنِّف استدلَّ على مذهب أهل السنَّة والجماعة بالآيات القرآنية الدالَّة على زيادة الإيمان صراحةً وعلى نقصه باللزوم؛ ذلك لأنَّ كلَّ دليلٍ يدلُّ على الزيادة فهو يدلُّ على النقصان وبالعكس، فالزيادة والنقص متلازمان، فلا يُعْقَل أحدهما دون الآخَر، وقد احتجَّ على هذا المعنى علماءُ أهل السنَّة، فقد قيل لسفيان بن عيينة: «الإيمان يزيد وينقص؟» قال: «أليس تقرؤون: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ في غير موضعٍ؟»، قيل: «ينقص؟» قال: «ليس شيءٌ يزيد إلاَّ وهو ينقص» [رواه الآجرِّيُّ في «الشريعة» (١١٤)، انظر «تهذيب السنن» لابن القيِّم (١٢/ ٤٥٠)]. وقال البيهقي في [«شعب الإيمان» (١/ ١٦٠)] عند تناوله للآيات المصرِّحة بزيادة الإيمان: «فثبت بهذه الآياتِ أنَّ الإيمان قابلٌ للزيادة، وإذا كان قابلاً للزيادة فعُدِمت الزيادةُ كان عدمُها نقصانًا».
وقال ابن حزمٍ في «الفصل» (٣/ ٢٣٧) بعد أن قرَّر وجودَ الزيادة في الإيمان: «فبالضرورة ندري أنَّ الزيادة تقتضي النقصَ ضرورةً ولا بدَّ؛ لأنَّ معنى الزيادة إنما هي عددٌ مضافٌ إلى عددٍ، وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقينٍ ناقصٌ عند عدم الزيادة فيه». وقال البغداديُّ في [«أصول الدين» (٢٥٣)]: «…وإذا صحَّت الزيادةُ فيه كان الذي زاد إيمانُه قبل الازدياد أنقصَ إيمانًا منه في حال الازدياد». ونقل النوويُّ في [«شرح مسلم» (١/ ١٤٦)] عن ابن بطَّالٍ أنه قال: «فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقصٌ».
وعليه، فالآيات القرآنية المصرِّحة بزيادة الإيمان استدلَّ بها المصنِّف على وجه التنصيص بزيادة الإيمان بالمنطوق، وعلى النقصان باللزوم، فكانت دليلاً عليهما معًا.
(٢) جزءٌ من الآية ٢ من سورة الأنفال.
وفي مَعْرِض ذكر هذه الآية، قال ابن تيمية في [«مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٢٨)]: «وهذه زيادةٌ إذا تُليت عليهم الآيات، أي: وقتَ تُلِيَتْ ليس هو تصديقهم بها عند النزول، وهذا أمرٌ يجده المؤمن إذا تُليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه مِن علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلاَّ حينئذٍ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشرِّ ما لم يكن، فزاد علمُه بالله ومحبَّتُه لطاعته، وهذه زيادة الإيمان».
(٣) الآية ١٧٣ من سورة آل عمران.
قال ابن تيمية في [«مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٢٨)] عند هذه الآية: «فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدوِّ لم تكن عند آيةٍ نزلت فازدادوا يقينًا وتوكُّلاً على الله، وثباتًا على الجهاد، وتوحيدًا بألاَّ يخافوا المخلوقَ بل يخافون الخالقَ وحده».
وقال الألوسي في [«روح المعاني» (٩/ ١٦٥)] عند تفسيره لهذه الآية: «وهذا أحد أدلَّة مَن ذهب إلى أنَّ الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب الجمِّ الغفير من الفقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين وبه أقول لكثرة الظواهر الدالَّة على ذلك من الكتاب والسنَّة من غير معارضٍ لها عقلاً، بل قد احتجَّ عليه بعضُهم بالعقل أيضًا، وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقةُ الإيمان لكان إيمان آحاد الأمَّة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويًا لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، واللازم باطلٌ فكذا الملزومُ».
قلت: وقد اكتفى المصنِّف في هذا المقام بالاستدلال بآيتين وحديثٍ، وإلاَّ فلزيادة الإيمان ونقصانه أدلَّةٌ كثيرةٌ، عقد الآجرِّيُّ في [«الشريعة» (١١٦)] واللالكائيُّ في [«شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة» (٣/ ١٨)] بابًا سيقت فيه جملةٌ من الأدلَّة من الكتاب والسنَّة والآثار الدالَّة على زيادة الإيمان ونقصانه.
(٤) الحديث يدلُّ على زيادة الإيمان ونقصانه حيث بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مراتبَ إنكار المنكر، وأنَّ الناس يتفاضلون في الإيمان بحسَب الاستطاعة في القيام بهذه المراتب بالتغيير باليد أو باللسان أو بالقلب، فيزداد إيمانُ مَن ينكر المنكرَ بيده في حين يضعف إيمانُ مَن يكرهه بقلبه، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» دليلٌ صريحٌ على أنَّ الإيمان ينقص بنقص الطاعة وارتكابِ المعصية، كما أنه في المقابل يزيد بفعل الطاعة والابتعاد عن المعصية.
هذا، ويُعَدُّ حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أحدَ الأدلَّة من السُّنَّة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضُل أهله، وقد بوَّب له النسائيُّ في «سننه» (٨/ ١١١) «باب تفاضُل أهل الإيمان»، والنوويُّ في [«شرح مسلم» (٢/ ٢١)] «باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأنَّ الإيمان يزيد وينقص»، وابن منده في [«الإيمان» (١/ ٣٤١)] «ذكر خبرٍ يدلُّ على أنَّ الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص».
وحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه -وإن لم يظهر فيه التصريحُ بأنَّ مراتب الإنكار هي من الإيمان، ولا وَرَد التصريحُ بأنَّ الإنكار القلبيَّ هو آخر حدود الإيمان- إلاَّ أنَّ ما رواه مسلمٌ في «صحيحه» (٢/ ٢٧) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»، أفاد ما أفاده الحديثُ السابق مع زيادة التصريح بالفائدتين السابقتين.
وحقيقٌ بالتنبيه أنه ليس المرادُ مِن قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» نفيَ أصل الإيمان عمَّن لم ينكر المنكر، وإنما المراد به أنه ليس وراء مرتبة القلب من الإنكار ما يصلح أن يدخل في مسمَّى الإيمان حتى يقوم به المؤمن، قال ابن تيمية في [«مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٢)]: «أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو مِن الإيمان ولا قدر حبَّةٍ من خردلٍ، والمعنى: هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا مِن الإيمان شيءٌ، ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيءٌ».
كما يجدر التنبيه -أيضًا- أنَّ كلَّ الرواياتِ الواردةَ في أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهي باطلةٌ وموضوعةٌ -بلا ريبٍ- أي: مكذوبةٌ على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، قال ابن القيِّم في [«المنار المنيف» (١١٩)]: «وكلُّ حديثٍ فيه أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذبٌ مختلَقٌ»، وهذا بغضِّ النظر عن مصادمته لنصوص الكتاب والسنَّة المصرِّحة بزيادة الإيمان ونقصانه.
(٥) الحديث لم يخرجه البخاريُّ -وهو وهمٌ من المصنِّف-، وإنما رواه مسلمٌ في «الإيمان» (٢/ ٢٢) باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأبو داود في «الملاحم» (٤/ ٥١١) باب الأمر والنهي، والترمذيُّ في «الفتن» (١/ ٤٧٠-٤٧١) باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنسائيُّ في «الإيمان» (٨/ ١١١، ١١٢)، باب تفاضُل أهل الإيمان، وابن ماجه في «إقامة الصلاة» (١/ ٤٠٦)، باب ما جاء في صلاة العيدين، وفي «الفتن» (٢/ ١٣٣٠)، باب الأمر بالمعروف، وأحمد في «مسنده» (٣/ ١٠، ٢٠، ٥٢، ٩٢)، من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه.
... يتبع ...
الجزائر في: ١٥ رمضان ١٤٢٨ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧م
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 5655 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)