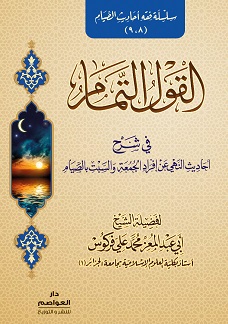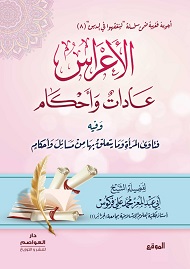- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ١٢٧٧
الصنف: فتاوى منهجية
الجواب على حصرِ مُرادِ المتكلِّمِ في الإجمالِ
نصُّ الشبهة:
ورَدَ في الفتوَى رقم: (٦٨٥) وعنوانُها: «الجرحُ والتَّعديلُ مِنْ مسائلِ الاجتهادِ»: «أمَّا إِنْ جُهِلَ مُرادُه فيُنظَر في سيرةِ المجتهدِ: إِنْ كانت حسنةً حَمَلَ كلامَهُ على الوجه الحسن لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ﴾ [الأعراف: ٥٨]، وإِنْ كانت سِيرتُه غيرَ ذلك حُمِل كلامُه على الوجه السيِّئ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗا﴾ [الأعراف: ٥٨]».
وهذا التقريرُ مُخالِفٌ للصَّواب؛ لأنَّ الذي عليه السَّلفُ وأئمَّةُ الدِّين: الحكمُ على الإجمالِ المُوهِمِ لمعنًى باطلٍ بالخطإ والبدعة وغيرِ ذلك بحسَبِه، وإِنْ كان قصدُ صاحبِ الإجمال حسنًا وكان عالمًا سُنِّيًّا فاضلًا؛ وفي ذلك يقول ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «ومَنْ قال: «لفظي بالقرآن غيرُ مخلوقٍ» أو «تلاوتي..» دَخَل في ذلك المصدرُ الذي هو عمَلُه، وأفعالُ العبادِ مخلوقة؛ ولو قال: «أرَدْتُ به أنَّ القرآنَ المتلوَّ غيرُ مخلوقٍ لا نفسُ حركاتي» قِيلَ له: «لفظُك هذا بدعةٌ، وفيه إجمالٌ وإيهامٌ، وإِنْ كان مقصودُك صحيحًا»؛ كما يقال للأوَّل إذا قال: «أرَدْتُ أنَّ فعلي مخلوقٌ»: «لفظُك ـ أيضًا ـ بدعةٌ، وفيه إجمالٌ وإيهامٌ، وإِنْ كان مقصودُك صحيحًا»؛ فلهذا مَنَع أئمَّةُ السُّنَّة الكبارُ إطلاقَ هذا وهذا»(١).
فشيخُ الإسلام يحكم على مَنْ أَطلقَ هذا اللفظَ المُجمَلَ ـ مع حُكمِه بحُسنِ قصدِ القائل ـ بأنه أَوهَمَ البدعةَ وجَعَل للجهميَّة طريقًا إلى غرضهم، ولم يُحكِّمْ قاعدةَ: حملِ المُجمَل على المفصَّل.
ويَلْزَمُ ممَّا سَبَق مِنْ خلال الفتوى لوازمُ باطلةٌ منها: أنه إذا صدَرَتْ كلمةٌ مُجمَلةٌ تتضمَّن سبًّا لله أو لرسولِه أو كتابِه أو لأحَدِ الأنبياء أو الصحابة مِنْ سُنِّيٍّ ومُبتدِعٍ، فكيف تُحمَلُ مِنَ السُّنِّيِّ على الحقِّ ومِنَ المُبتدِع على الباطل؛ ونفسُ الأمر بالنسبة للكلمة المُجمَلة التي تتضمَّن قذفًا أو رِدَّةً.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فينبغي أَنْ يُعلَم أنَّ الخِطابَ ـ مِنْ حيث دلالتُه على مرادِ المتكلِّمِ ـ أعمُّ مِنْ أَنْ يكونَ قاصرًا على الإجمالِ، فقَدْ يكون نصًّا لا يحتمل معنى غيره، وقد يكونُ راجحًا في أحَدِ معنَيَيْهِ يتبادرُ الذهنُ إليه مِنْ جهة اللَّفظ فهو الظَّاهر، وقد يُصرَفُ منه إلى المُحتمَلِ المرجوحِ مِنْ جهةِ دليلٍ مُنفصِلٍ فهو المؤوَّلُ؛ وعليه فدعوَى قصورِه على الإجمالِ المُوهِمِ لمعنًى باطلٍ أخصُّ في الاعتراضِ والنَّقدِ مِنَ المعنَى المطلوبِ؛ إذ إنَّ المعترِضَ حَصَرَ الجملةَ المذكورةَ في مرادِ المتكلِّم بكلامٍ مُجمَلٍ دون بقيَّةِ المعانِي المعبَّرِ عنها في الخطابِ؛ والَّتي تكونُ مِنْ مرادِ المتكلِّمِ، وبيانُ ذلك:
أنَّ الأصلَ في الكلامِ: دلالتُه على مرادِ المتكلِّمِ؛ حيثُ إنَّه لا يُعرَفُ مرادُه إلَّا بالألفاظِ الدَّالَّةِ عليه، وليس له مِنْ سبيلٍ إلى معرفةِ مُرادِه غيرُ كلامِه وألفاظِه الدَّالَّةِ على ما في نفسِه مِنَ المعاني، ولكنَّه ـ مِنْ حيث الإشكالُ ـ قد تكون ألفاظُ المتكلِّم غيرَ مفهومةِ المعنى لا تدلُّ دلالةً واضحةً على المرادِ؛ أو مُنتفِيَةَ المعنى في الشَّاهد، إمَّا لعدمِ استحضارِ العبارةِ اللائقةِ للفهمِ أو لعدمِ التَّنسيقِ والتَّرتيبِ فيما يؤدِّيه مِنَ الكلامِ، أوْ قد يتعرَّض إلى جُزئيَّةٍ مِنْ مسألةٍ أخرى ويُدرِجُها ضِمنَ عمومِ كلامِه، وقد يريد المتكلِّمُ التَّعميةَ والتَّلبيسَ أو التوريةَ أو الإلغاز على السَّامعِ ونحو ذلك؛ وهذا بخلافِ ما إذا كان كلامُه وألفاظُه يُفهَم معناها ـ في لغةِ التَّخاطُبِ ـ على وجه الوضوح، فإنَّ هذا إنَّما يكونُ عند إرادةِ المتكلِّمِ البيانَ والهدايةَ والإرشادَ، والإفصاحَ عن مُرادِه مِنْ غيرِ إشكالٍ يعترضُه.
وقَدْ ذَكَر ابنُ القيِّم وابنُ أبي العزِّ ـ نقلًا عنه ـ رحمهما الله عِدَّةَ طُرُقٍ يُعرَف بها مُرادُ المتكلِّم منها: التصريحُ بإرادة المعنى المطلوبِ بيانُه، وتكون المعاني المُرادُ بيانُها مشهودةً عند المُخاطَب أو معقولةً له إذا كان على درايةٍ بِلُغةِ المتكلِّم: ألفاظِها وتراكيبِها، ومنها: استعمالُ اللَّفظ الذي له معنًى ظاهرٌ بالوضعِ مع تجريدِ الكلامِ مِنَ القرائنِ الصَّارفةِ عن الظَّاهر، ومنها: أَنْ يكون كلامُه محتفًّا بالقرائنِ الدَّالَّةِ على مُرادِه(٢).
هذا، وقد تغيبُ بعضُ هذه الطُّرُقِ، حيث يكون للمتكلِّم معنًى ظاهرٌ غيرُ ما دلَّت عليه القرائنُ مِنْ مَعانٍ مخالفةٍ لمُرادِه، أو غيرِ مشهودةٍ للمخاطَب أو غيرِ معقولةٍ له؛ وعليه يتبيَّن: أنَّ الأمرَ ليس قاصرًا على المُجمَلِ كما يدَّعِيه المعترضُ، وليس كُلُّ ما يحتملُه اللفظُ مِنَ المعاني يكون مُرادَ قائلِه؛ فاحتمالُ اللَّفظِ للمعنى شيءٌ، ودلالتُه عليه شيءٌ آخَرُ، وحملُ اللَّفظِ على المعنى قد يُرادُ به صلاحِيَتُه له أحيانًا أو وضعُه واستعمالُه له أحيانًا أخرى؛ لذلك لا يرتبطُ مُرادُ المتكلِّمِ بالإجمال دائِمًا.
أمَّا إذا كان كلامُه يحتَمِلُ أكثرَ مِنْ معنًى على وجهِ الإجمالِ، فإِنْ كان المجتهدُ عالمًا سُنِّيًّا وعلى سيرةٍ حسنةٍ؛ وأَطلَقَ كلامَه في سياقٍ مُفيدٍ فلا بُدَّ مِنْ قرائنَ دالَّةٍ على مُرادِه مع قطعِ الاحتمالاتِ الأخرى الَّتي لا تدلُّ عليها تلك القرائنُ، فيحملُه السامعُ عليها؛ فإِنِ انتفَتِ القرائنُ الدَّالةُ على مُرادِه فإنَّه يُحمَلُ على الوجهِ الحسنِ مع بيانِ الوجوهِ الباطلةِ الأخرى الَّتي قد يحتملُها كلامُه المُجمَلُ المُوهِمُ للخطإ والبدعة، وليس ذلك مِنْ حملِ المُجمَلِ على المفصَّل ـ كما يدَّعِيه المعترضُ ـ وإنَّما هو حملُ كلامِه المُجمَلِ على المعنى الصحيحِ مِنْ بين مُحتمَلاتِه(٣)؛ الَّذي يتوافقُ مع عقيدتِه وسيرتِه وسلوكِه؛ بخلافِ ما إذا كان في كلامِه معنًى واحدٌ، أو عيَّن المعنى الضَّعيفَ المرجوحَ مِنَ المُجمَلِ فيما يسوغُ فيه الاجتهادُ؛ فإنَّ نصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ قد تَواترَتْ في إعذارِ المخطئِ في اجتهادِه وله أجرُ اجتهادِه، ولا يُحمَلُ المُجمَلُ على غيرِ ما عيَّنه في هذه الحالِ؛ وهذا كُلُّه إذا كان مُجتهِدًا؛ أمَّا إِنْ لم يكن مُجتهِدًا وأخطأ في حُكم الله دون بذلِ ما في وُسعِه وكُلِّفَ به مِنْ النظر أو سؤالِ مَنْ عنده عِلمُه أو خالطه هوًى فيأثَمُ لتفريطِه وهواه؛ قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «فمَنْ كان خَطَؤُه لتفريطه فيما يجبُ عليه مِنِ اتِّباعِ القرآنِ والإيمانِ مثلًا، أو لِتَعدِّيهِ حدودَ اللهِ بسلوكِ السُّبُلِ التي نهى عنها، أو لاتِّباعِ هواهُ بغيرِ هدًى مِنَ الله: فهو الظَّالمُ لنفسِه وهو مِنْ أهلِ الوعيدِ؛ بخلاف المجتهدِ في طاعةِ اللهِ ورسولهِ باطنًا وظاهرًا، الذي يَطلبُ الحقَّ باجتهادِه كما أمَرَه اللهُ ورسولُه؛ فهذا مغفورٌ له خطؤُه»(٤)، علمًا أنَّ ما استشهدَ به المعترِضُ مِنْ كلامِ ابنِ تيميةَ ـ رحمه الله ـ لا يُؤيِّده؛ لأنَّ ابنَ تيميةَ رحمه الله ـ مِنْ خلالِ سياقِ كلامِه وسباقِه ـ إنما أَنكرَ الإطلاقَ في العبارة دون بيان مُراد المتكلِّم الذي هو ـ في الأصل ـ محورُ الشاهد.
● وأمَّا قولُه: «إذا صدرَتْ كلمةٌ مُجمَلةٌ تتضمَّن سبًّا لله ولرسوله..» فقَدْ سَبَقَ وأَنْ أجَبْتُ عن هذا في الردِّ عنِ اعتراضٍ سابقٍ في الفتوى رقم: (١٢٢٥) الموسومة ﺑ: «الاعتراض على تلازم الظَّاهر والباطنِ في الحكمِ بالكُفر»، فأَنقُلُ تفصيلَ شاهِدِها على ما يأتي: «.. غير أنَّه ينبغي التَّفصيلُ في الاعتقادات والأقوالِ والأعمال الكُفريَّة بين قِسمَيْن:
أحَدُهما: ما لا يحتمل إلَّا الكُفرَ فقط، فإنَّه لا اعتبارَ ـ في هذا القِسم ـ للقُصود والنِّيَّات، ولا نظرَ إلى قرائنِ أحواله، وإنَّما الحكمُ بالكفر على ظاهرِ الفِعلِ المُكفِّر، بِغَضِّ النَّظر عن قصدِه ونِيَّتِه وقرائنِ حالِه؛ غيرَ أنَّ الحكم بالكفر على الفعل لا يَلْزَمُ منه تكفيرُ الفاعل؛ لأنَّ تكفيرَه يتوقَّف على تحقُّق الشروطِ وانتفاء الموانع(٥).
ومِنْ تطبيقاتِ هذا القسم: سبُّ اللهِ تعالى أو سبُّ رسولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وهو كفرٌ قوليٌّ، أو إهانةُ المُصحفِ أو نحوُ ذلك وهو كفرٌ عمليٌّ؛ فهاتان الصورتان لا تحتملان إلَّا الكفرَ؛ لذلك لا ننظر فيهما إلى قصد الفاعل ونِيَّتِه وقرائنِ أحواله؛ لعدمِ وجودِ احتمالٍ آخَرَ مُشارِكٍ له في اللَّفظِ أو الفعلِ؛ لذلك كان الحكمُ بالكفرِ فيه يتناول الظَّاهرَ والباطنَ(٦)؛ وضِمْنَ هذا المعنى قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «إنَّ سَبَّ اللهِ أو سَبَّ رسولِه كفرٌ ظاهرًا وباطنًا، وسواءٌ كان السَّابُّ يعتقد أنَّ ذلك مُحرَّمٌ أو كان مُستحِلًّا له أو كان ذاهلًا عن اعتقاده؛ هذا مذهبُ الفقهاء وسائرِ أهلِ السُّنَّة القائلين بأنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ»(٧)، وقال ـ أيضًا ـ: «لو أخَذَ يُلقي المُصحَفَ في الحُشِّ ويقول: «أشهد أنَّ ما فيه: كلامُ الله»، أو جَعَل يقتل نبيًّا مِنَ الأنبياء ويقول: «أشهد أنَّه رسولُ الله» ونحو ذلك مِنَ الأفعال التي تُنافي إيمانَ القلب؛ فإذا قال: «أنا مؤمنٌ بقلبي مع هذه الحالِ» كان كاذبًا فيما أَظهرَه مِنَ القول»(٨).
ومِثلُ هذا في باب الفقه الذي لا يحتمل إلَّا معنًى واحدًا: التَّلفُّظُ بالطَّلاق الذي معناهُ: المُفارَقةُ الزَّوجيَّة؛ فإنَّ الحُكمَ بالطَّلاقِ واقعٌ بقوله وهو طلاقُه الصَّريح، بِغَضِّ النَّظر عن الفاعل؛ أمَّا إثباتُ العلاقة الزَّوجيَّة أو نفيُها فهو مُتوقِّفٌ على وُجود الشُّروطِ وانتفاءِ الموانع.
ثانيهما: ما يحتمل الكفرَ وعدَمَه، وليس الاعتبارُ في الحكم بالكفر ـ في هذا القسم ـ على ظاهر الفعل، وإنما المُعتبَرُ فيها: القُصودُ والنيَّاتُ وقرائنُ الأحوال.
ومِنْ تطبيقاته: السُّجودُ لغير الله تعالى؛ فإنَّه يدور حُكمُه بحسَبِ قصده ونِيَّتِه وقرائنِ حالِه؛ فقَدْ يكون قصدُه بالسُّجود لغير الله تعالى: التَّعبُّدَ للمسجودِ له والتَّقرُّبَ إليه، فهو ـ في هذه الحال ـ كفرٌ؛ كما قد يكون قصدُه للفعل: التَّحيَّةَ والتَّقديرَ، أو التَّمثيلَ والحكاية بالفعل، فهو ـ بهذا الوجه ـ معصيةٌ.
ويدلُّ عليه استفصالُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مِنْ مُعاذ بنِ جبلٍ رضي الله عنه عن سُجوده له ـ على القول بصحَّةِ الحديث ـ ولم يحكم النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على فعلِ مُعاذٍ رضي الله عنه بالكفر بمُجرَّدِ سجوده؛ فدلَّ ذلك على أنَّ المُعتبَر في ذلك إنَّما هو المقصودُ مِنْ عملِه؛ لذلك اكتفى بنهيه عن الفعل دون استتابَتِه مِنَ الكفر(٩).
ومِنْ تطبيقاتِ هذا القسمِ ـ أيضًا ـ: إفشاءُ سِرِّ المسلمين إلى أعدائهم؛ فهو دائرٌ بين مَقاصِدَ مُختلِفةٍ: إمَّا أَنْ يقصد مُوالاةَ الكُفَّارِ وإعانَتَهم على المسلمين، وهو ـ بهذا المعنى ـ كفرٌ وخيانةٌ عُظْمَى، وإمَّا أَنْ يَقصِدَ ـ بعمله هذا ـ إلى تحقيقِ غرضٍ مادِّيٍّ أو مصلحةٍ دُنْيويَّةٍ أو لدفعِ ضررٍ، وهو ـ بهذا المعنى ـ معصيةٌ.
ومِنْ أجلِ هذا الاحتمالِ استفصل النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في قصَّةِ حاطبِ بنِ أبي بَلْتَعةَ رضي الله عنه، ولم يحكم على فعله بالكفر بمُجرَّدِ مُراسَلتِه لقُرَيْشٍ ومُكاتَبَتِه إيَّاهم بأمرِ مَسيرِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم والمسلمين إليهم لفتحِ مكَّةَ(١٠)؛ والقصَّةُ مشهورةٌ أَخرجَها البخاريُّ ومسلمٌ(١١)» انتهى.
وأمَّا اللوازم فقَدْ تقدَّم الجوابُ عنها في اعتراضٍ سابقٍ، ويمكن نقلُه هنا على الوجه التالي: «أمَّا ما ادَّعاه المعترضُ مِنْ لوازم القولِ المسكوتِ عنها فغيرُ مسلَّمٍ: لأنَّ لوازِمَ القولِ المسكوتَ عنها ليست قولًا للمُعترَضِ عليه ما لم يَلتزِمْها بعد أَنْ تُذكَرَ له ويَلتزِمَها ويَذكُرَ عُذْرَه أو حُجَّتَه فيها؛ وعلى المعترض ـ في ذلك ـ مُطالَبتان: الأولى: إقامةُ البرهانِ على لزومِ ما ادَّعاه مِنْ لوازِمَ لقولِ خصمِه، والثَّانيةُ: إقامةُ البرهان على بطلانِها ـ في نفسِها ـ إِنْ لم تكن ظاهرةَ البُطلانِ؛ علمًا أنَّ نِسبَتَها إليه دون هذا الشرطِ فإنَّما هو تقويلٌ لهُ ما لم يَقُلْ مِنَ الباطلِ وافتراءٌ عليه؛ لانتفاءِ الدَّليلِ على لزومها له وعلى بطلانها في نفسها»(١٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ ربيعٍ الآخِر ١٤٤٣ﻫ
المُـوافـق ﻟ: ٠٢ ديسمـبـر ٢٠٢١م
(١) «درء تعارُضِ العقل والنقل» لابن تيميَّة (١/ ١٤٩).
(٢) انظر: «الصواعق المُرسَلة» لابن القيِّم (١/ ٢٠٢)، «شرح الطحاويَّة» لابن أبي العزِّ (٢١٥).
(٣) علمًا أنَّ ابنَ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ أدرجَ تطبيقَ الآيةِ ضِمنَ «قياسِ الدَّلالةِ» الَّذي عرَّفهُ في «إعلام الموقعين» (١/ ١٣٨) بقولهِ: «فَهُوَ الجَمعُ بينَ الأصلِ والفرعِ بدليلِ العلَّةِ ومَلزومِها»؛ ومعنى ذلك: أنَّه لا يُجمَع فيهِ بعَينِ العلَّةِ؛ وإنَّما بما يدلُّ عليها ممَّا يَلزَمُ مِنَ الاشتراكِ في عينِ العلَّةِ؛ ومِنَ الأمثلةِ التَّطبيقيةِ ما ساقهُ ابنُ القيِّمِ بعد التعريف (١/ ١٣٩ ـ ١٤٠) بما نصُّهُ: «ومنه قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا سُقۡنَٰهُ لِبَلَدٖ مَّيِّتٖ فَأَنزَلۡنَا بِهِ ٱلۡمَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِۚ كَذَٰلِكَ نُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٥٧ وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗاۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَشۡكُرُونَ ٥٨﴾ [الأعراف]، فأخبر سبحانه أنَّهما إحياءان، وأنَّ أحدهما مُعتبَرٌ بالآخَرِ مَقِيسٌ عليه، ثمَّ ذكر قياسًا آخَرَ، أنَّ مِنَ الأرض ما يكون أرضًا طيِّبةً فإذا أَنزلَ عليها الماءَ أَخرجَتْ نباتَها بإذن ربِّها، ومنها ما تكون أرضًا خبيثةً لا تُخرِج نَباتَها إلَّا نكدًا، أي: قليلًا غيرَ مُنْتَفَعٍ به، فهذه إذا أَنزلَ عليها الماءَ لم تُخرِج ما أَخرجَتِ الأرضُ الطيِّبة، فشَبَّه سبحانه الوَحْيَ الذي أنزله مِنَ السَّماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحُصُول الحياة بهذا وهذا، وشَبَّه القلوبَ بالأرض إذ هي مَحَلُّ الأعمال، كما أنَّ الأرض محلُّ النبات، وأنَّ القلبَ الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تُخرِج نباتَها به إلَّا قليلًا لا ينفع، وأنَّ القلبَ الذي آمَنَ بالوحي وزَكَا عليه وعَمِل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتَها بالمطر؛ فالمؤمن إذا سَمِعَ القرآنَ وعَقَله وتَدَبَّرَه بانَ أثرهُ عليه، فشُبِّه بالبَلدِ الطيِّب الذي يمرعُ ويخصب ويحسن أثرُ المطر عليه فيُنبِت مِنْ كُلِّ زوجٍ كريمٍ، والمُعْرِضُ عن الوحي عَكْسُه».
(٤) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣/ ٣١٧).
(٥) مِنْ موانع الكفر: الجهل: على تفصيلٍ ذَكَره العلماء، ومَحَلُّه المسائلُ الخفيَّة لا الظَّاهرة، [انظر ضوابطَ مسألةِ العذر بالجهل في خاتمةِ مؤلَّفي: «توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعيَّة على العذر بالجهل في المسائل العَقَديَّة»]؛ ومنه الخطأ: فقَدْ يكون ناشئًا عن غيرِ قصدٍ كسبقِ لسانٍ ونحوِه، ومِثلُ هذا لم يختلف العلماءُ في العذر به، وقد يكون الخطأُ ناشئًا عن اجتهادٍ أو قصورٍ في فهم الأدلَّة الشَّرعيَّة، وهو ما يُعرَف بمانع التَّأويل؛ ومِنْ ذلك مانعُ الإكراه؛ ولكُلِّ مانعٍ مِنْ هذه الموانعِ ضوابطُ وشروطٌ مُعتبَرةٌ للعذر به.
(٦) انظر الفتوى رقم: (٦٢٥)، الموسومة ﺑ: «في ناقض الإيمان القولي: سبُّ الله عزَّ وجلَّ» على الموقع الرسمي.
(٧) «الصَّارم المسلول» لابن تيمية (٣/ ٩٥٥).
(٨) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٦١٦).
(٩) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤/ ٣٦٠).
وقد أَخرجَ ابنُ ماجه وغيرُه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: «أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ؛ فَوَدِدْتُ ـ فِي نَفْسِي ـ أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا ـ وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ ـ لَمْ تَمْنَعْهُ» أخرجه ـ بهذا اللفظِ ـ ابنُ ماجه في «النكاح» بابُ حقِّ الزوج على المرأة (١٨٥٣)، وأحمدُ بنحوه في «مُسنَده» (١٩٤٠٣). والحديث ذَكَره الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٠١، ٧/ ١٠٩٧) وفي «الإرواء» (٧/ ٥٥) وفي «صحيح ابنِ ماجه» (٢/ ١٢١)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ أبي أَوْفى رضي الله عنهما؛ قال الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٠٢): «وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ»؛ ولفظُ أحمد: «قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ ـ أَوْ قَالَ: الشَّامَ ـ فَرَأَى النَّصَارَى..»؛ [وانظر الفتوى رقم: (٩١٧) الموسومة ﺑ: «في توجيه حديثَيْ عائشة ومعاذٍ رضي الله عنهما في العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد» على الموقع الرسميِّ]. ووَرَد الحديثُ عن جماعةٍ مِنَ الصحابة منهم: أبو هريرةَ وعائشةُ وأنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عن الجميع؛ [انظر: «سنن أبي داود» (١/ ٦٥٠)، و«سنن الترمذي» (٣/ ٤٦٥)، و«سنن الدارمي» (١/ ٤٠٦)، و«مستدرك الحاكم» (٢/ ٢٠٤)].
(١٠) انظر: «الأمَّ» للشافعي (٤/ ٢٦٤).
(١١) أخرجه البخاريُّ (٣٠٠٧، ٣٩٨٣، ٤٢٧٤، ٤٨٩٠، ٦٢٥٩، ٦٩٣٩)، ومسلمٌ (٢٤٩٤)، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ ولفظُه: عن عُبَيْدِ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا»، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: «أَخْرِجِي الكِتَابَ»، فَقَالَتْ: «مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ»، فَقُلْنَا: «لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ»، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: «مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ» إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟»، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ ـ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ـ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا، وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ»، قَالَ عُمَرُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ»، قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».
(١٢) انظر الفتوى رقم: (١٢٧٥) الموسومة ﺑ: «الجواب عن الاعتراض على «اختلاف السَّلف في المَسائل العقديَّة الفرعيَّة»» على الموقع الرسمي.
- قرئت 192249 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)